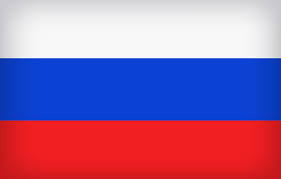“لاَ تَكْذِبُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، إذْ خَلَعْتُمُ الإِنْسَانَ الْعَتِيقَ مَعَ أَعْمَالِهِ، وَلَبِسْتُمُ الْجَدِيدَ… (كولوسي 3: 9-10)
حدَّثَ الرّسول بولس تيطُس عن -“الله الْمُنَّزَه عَنِ الْكَذِبِ”- إنّه إعلانٌ رائعٌ وبسيطٌ في نفس الوقت. ليس الله سرابًا أو محض الخيال، إنّه لا يتغيّر مع مرور الزّمن أو يكيّف وجوده مع الظّروف المتغيّرة. كلّ إعلاناته كاملة وصادقة، لأنّ الله هو الحقّ بكلّ ما للكلمة من معنى. بالمقابل، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، ليس البشر أبدًا كما يُظْهِرُون، فوراء مظهرهم الخارجي تختفي الكثير من نقاط الضّعف والسّبل المعوجّة. أمّا الرّب فيبدو بالضّبط كما وصفَهُ الكتاب المقدس.
الله هو أيضًا الحقّ بمعنى أنّه لا يخطئ أبدًا. كثيرًا ما تكون تصريحاتنا خاطئة ليس لكوننا نكذب، بل لأنّنا نجهل الوقائع، أمّا الله فلا يمكن أبدًا أن يخطئ لأنّ معرفته وحكمته المطلقتيْن تكمّلان حقّه. من المريح جدًّا أن نتذكّر أنّ وعود الله قائمة على هذا المزيج من الصّفات الإلهيّة. إنّ تعهّداتنا هي رهن التّطوّرات المستقبليّة المجهولة، أمّا تعهّدات الله فهو يحقّقها على ضوء معرفته المطلقة لذلك لا تفشل أبدًا.
هناك فكرٌ آخر يبعثُ على الارتياح الشّديد حول صدق الله، وهو أنّ هذا الصّدق يجسّد كلّ “نواحي” كيانه الأبدي. عندما يقول الله شيئًا، فهو يعنيه جدًّا. إنّه لا يقوم بتصريحات نُطْقُها سليم كالأكاديمي أو السياسي الّذي يفتقر ربّما إلى الإحساس. إنّ كلمات الله نابعة من كامل كيانه المطلق. أمّا نحن فكثيرًا ما نقول أشياء حقيقيّة، لكنّنا لا نضع عليها قلبًا. فقد نقدّم على سبيل المثال دعوةً غير محدّدة لشخص ما لزيارتنا، بينما نحن لا نعنيها إلّا جزئيًّا، ربّما لأنّنا مرهقون أو لا نملك وقتًا، لذا نشعر بالارتياح لو لم يلبِّ ذلك الشّخص دعوتنا. نحن صادقون بشكل معقول، ولكنّنا لسنا حقيقيّين تمامًا في ما نقوله. في حين أنّ الله عندما يقدّم دعوته الفعليّة للنّفوس الهالكة فهو يعني ذلك من صميم قلبه المُحِبّ العظيم.
منذ سنوات عديدة تنازعت شخصيّتان سياسيّتان بارزتان من نفس الحزب، وقد دعا أحدُهم الآخر “آلة حساب جافّة”، قال ذلك بوضوح، ولكنّه أقرّ أيضًا بأنّ الشّخص المُهان كان اقتصاديًّا بارعًا. قَصَدَ القول من خلال تلك الشكوى إنّه يفتقر إلى الرّحمة أو الإحساس أو القلب، لكن لا يمكن أن يُقال ذلك عن الله القدير. إنّ الخلاص الّذي صمّمه الله ليس مجرد حلٍّ عملي لمشكلة الخطيّة، إنّما هو تعبير عن محبّته العظيمة للمُختارين. عندما وَهَبَ لنا الله نفسه في المسیح، كان عمله هذا نابعًا من محبّته العمیقة وحنانه الّذي لا يُعبَّر عنه، كونه صادقًا بكلّ كيانه وقدرته.
أكثر من مجرّد إهانة
قد يعتقد القارئ العادي أنّ المقصود من الوصيّة التاسعة هو مجرّد النّهي عن إهانة الآخر، ولكن لو ألقيْنا نظرة سريعة على معنى الكلمات، يظهر بسرعة أنّ المعاني أشمل بكثير. إنّ الكلمة العبريّة المترجمة تَشْهَد (“لا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُورٍ”) تعني – تتوق إلى، تفكّر، تُعِر انتباهًا، تصغي إلى. وقد تعني أيضًا تقدّم أو تُوصِل. إنّ الوصیّة لا تنهي فقط عن الإصغاء (عن وعيٍ) إلى شهادة زور، أو الإدلاء بها، بل تحظّر أيضًا أن تكون للمرء أيّة علاقة بها من قريب أو بَعيد. يمكننا إعادة صياغة الوصيّة بهذه الطريقة: “لا يجوز لك أن تلفّق شهادة زور، أو تعيرَها انتباهك أو تفكّر فيها، أو تتناقلها”. يجب ألا نقدّم شهادة زور أو نصغي لها.
بتعبير آخر، تقول الوصيّة – “لا يجوز لكَ أن تحمل شهادةً كاذبة في ذهنك، أو في قلبك، أو على شفتيك”. نخرقُ هذه الوصيّة إذا ملأنا أذهان الآخرين بأفكار مبالَغ بها أو من نسج خيالنا عن أخطاء الآخر، لأنّنا بذلك نشهد (نحمل ونفكّر بـ) شهادة كاذبة حتّى ولو لم ننطقْ بهذه الأفكار التّشهيريّة في نميمةٍ.
ما هي بالضّبط “شهادة الزّور”؟ إنّها كلّ رواية غير صادقة عن الأحداث، أو أي بيان غير صحيح. قد يكون قيل وقال أو افتراء ضدّ شخصٍ ما، أو قد تكون إفادة بمعلومات خاطئة عن النّفس لكسب إعجاب الآخرين. وتتضمّن الأعذار المزيّفة أو الملتوية الّتي تُختلَق للخروج من مأزق أو فضيحة. حتى المدح غير الواقعي هو كذب مؤذٍ إذ يقدّم فيه الشخص صورة مزيّفة عن الذّات، وينتج فخرًا. في أحيانٍ كثيرة قد يدمّر الأهل أطفالهم بسبب المدح الّذي لا أساس له من الصّحّة.
تقترح ترجمة الملك جيمس بالتأكيد أن تكون شهادة الزور “ضدّ قريبك”، ولكنّ الكلمة العبريّة المترجمة ضدّ مرنة جدًّا، وتعني أيضًا “مع قريبك أو على قريبك”.
لقد أنصفَ الكُتّاب القدامى المجال الكبير لهذه الوصيّة كما نرى من ماثيو هنري، الّذي كَتَبَ يقول: “الوصيّة التّاسعة مرتبطة بسيرتنا وسيرة جارنا. هذه الوصيّة تنهي عن، (1) التكلّم زورًا في أيّ مسألة، والكذب، والمراوغة، والتّخطيط أو التّصميم بهدف خداع جارنا. (2) التّحدّث دون وجه حق ضدّ جارنا. (3) حَمْل شهادة كاذبة ضدّه. . . القذف، التّغييب، النّميمة، المبالغة في نقل ما حَدَثَ وجعله أسوأ ممّا كان عليه، وذلك في سبيل تلميع صورتنا وبنائها على أنقاض سمعة جارنا”.
الانتصار على الكذب
إن الصّدق ثمين جدًّا عند الرّبّ، وحيوي جدًّا لخيْرنا الرّوحي لذا يجب على الحملة ضدّ لسان الكذب ألّا تهدأ أبدًا. بينما نصلّي، سيفعّل الرّوح القدس الله ضميرنا، ويجعله حسّاسًا لأيّ كذبة تنشأ، وسنجد أنفسنا في حالة تأهّبٍ واستعدادٍ لمواجهة اختلاقات “الجسد”. إذا اقترح قلبنا السّاقط أو الشّيطان كذبة، بمجرّد أن تبدأ آثار الطّبيعة السّاقطة فينا بتغذيتها، فإنّ ضميرنا سيزعجنا، وسنتأكّد من صدق كلمات الرّسول بولس: ” لأَنَّ الْجَسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ الرُّوحِ وَالرُّوحُ ضِدَّ الْجَسَدِ، وَهَذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِيدُونَ.”(غلاطية 5 :17). إنّ وخز الضمير يخبرنا أنّه الوقت لإيقاف الكذبة والصّلاة طلبًا لسلطانٍ على اللّسان، إذا لبّينا دعوته سيساعدنا الروح القدس، فيُهزَم إغراء الخطيّة، ويتمّ الوعد الضّمني في غلاطية 5 :16 – ” اسْلُكُوا بِالرُّوحِ فَلاَ تُكَمِّلُوا شَهْوَةَ الْجَسَدِ”.
في حين أنّنا إذا مَضَيْنا في الكذب (أو المشاركة في الإصغاء إلى النّميمة الكاذبة)، نخطئ ضدّ عمل الروح القدس المنذر والرّادع من خلال الضّمير، ونسيء ليس فقط إلى المبادئ بل أيضًا إلى الله المعين، وإذا فعلنا ذلك مرارًا وتكرارًا، ليتنا لا نستغرب إذا حَزِنَ الرّوح وفارقنا، وانعدمَ ضميرنا. عندما يصبح المؤمن واعيًا لكذبه بعد أن يكذب، ففي ذلك علامةٌ على أنّ صوت الضّمير أُسْكِتَ مرارًا، ولم يعدْ يعطي إنذارًا مسبقًا. يقول كاتب المزمور: “الْيَوْمَ إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ، فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ”، لنصلِّ دائمًا أن يعطينا الرّب ضمائر حسّاسة، وإذا استجاب الله الروح القدس صلاتنا، يجب أن نقدّر عطيّته، ونلاحظ كلّ إنذار ونتجاوب معه بشكل كامل.