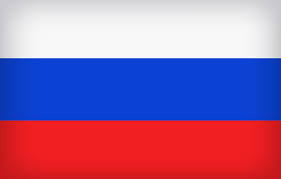كيف يمكن أن أتأكّد بأن الله موجود؟
كلّنا نمتلك الوعي الحدسي بوجود الله فهذا جزء من التركيبة البشرية. وهذا الوعي غالبًا ما يكون مدفونًا تحت تعقيدات الحياة، وقد يظهر فقط خلال لحظات الخوف والحاجة عندما يكون الإنسان بأمسّ الحاجة إلى الصلاة. وهذا ما يحصل مع الجندي داخل الخندق، ومع الطيّار خلال المعارك الجويّة، وكذلك مع البحّار أثناء غرق المركب، ومع المريض قبل خضوعه لعملية جراحية كبيرة، وفي العديد من المواقف والظروف الصعبة الأخرى. فالوعي الحدسي بوجود الله لا يُجيب عن السؤال التالي، “كيف يمكن أن أتأكّد بأن الله موجود؟” فالسؤال الذي يُطرح يحتاج إلى تأكيد. إليكم بعض الاقتراحات لتناول هذه المسألة الهامّة. علينا أن نطرح الأسئلة التالية: بماذا يُفيدني وجودي؟ ماذا يعني لي العالم من حولي والكون كلّه؟ هل من هدف لهذا العالم؟ من الواضح أنه لا معنى لهذا

الكون ولا أهمّية لحياة الإنسان إن لم يكن الله موجودًا. فنحن موجودون في هذه الحياة لكي نبقى أحياء، وننُجب ونُرضي أنفسنا.
ما هي نظرتي تجاه عقدة الحياة؟ هل يمكنني أن أستهجن وأعتبرها حادثة استثنائية حصلت منذ ملايين السنين؟ هل أتماشى مع النظريات المتخالفة والمتغيّرة حيال بداية الكون؟ هل يمكنني أن أُصدّق بأن كل الترتيب في الطبيعة وفي دورة الحياة والأنظمة الرائعة بالإضافة الى علامات كثيرة أخرى يُظهر بأنه لا بد من وجود مصمِّم رائع وراء هذا الكون كلّه ، وبأن الأمر لم يحصل صدفة؟ كل العلماء يتّفقون على أنّ الطبيعة تظهر وكأنّ أحدًا قد صمّمها.
كلّنا يعلم بأنّ كان مجموعة مذهلة من التفاعلات الكيميائية المعقّدة كانت لتحصل في ذلك الزمان في وقت واحد وبنظام متقن لكي تُحوّل الكائنات غير الحيّة إلى كائنات حيّة. هل يمكننا أن نتصوّر بأن أمرًا مستحيلاً كهذا كان ليحصل صدفة؟
هل يمكنني أن أُصدّق بأنه في لحظة من الماضي، اجتمعت مكوّنات متطوّرة بشكل عفوي وبتزامن تام لكي تخلق خليّة حيّة؟ وإذا سلّمنا جدَلاً بأنّ ذلك حصل فعلاً، هل يمكننا أن نصدّق بأنّ هذه الخليّة الحيّة يمكنها أن تُعطي الحياة التي نعرفها اليوم، من دون أي مساعدة أو توجيه من قِبل أي عامل مؤثِّر وذكي.
فكِّر في تركيبة جسم الإنسان الرائعة. وفكِّر أيضًا في بنية الإنسان العاطفية الدقيقة والعميقة.
ثمّ فكِّر في الجمال الخارق لبعض الأمور، جمال قد يتعدّى نطاق بصيرة الإنسان. فعلى سبيل المثال، إنّ المجهر يُظهر بأن كل ندفة ثلج هي مميّزة ومختلفة عن الأخرى، وكل ندفة تُشبه قطعة من المجوهرات المبتكرة والتي صُمّمت بشكل معقّد وغريب. هل هذا من نتاج الفوضى أم هو ناجم عن ترتيب ونظام، هل هو نتيجة صدفة أم أنه أمرٌ تمَّ تصميمه؟
كلّنا يعلم بأن الحوادث والصدف في حياتنا اليومية تؤدّي إلى الفوضى والارتباك. هل نصدّق بأن حادثة اعتباطية قد أنجبت نظامًا وتصميمًا ومنظومة معقّدة للحياة؟ بالطّبع، يتطلّب منك إيمانًا “أكبر” وإيمانًا أعمى لكي تؤمن بالصدفة أو الفوضى أكثر من أن تؤمن بالخالق والمصمِّم العظيم لهذا الكون.
لكن هنالك منحى آخر للتفكير في الموضوع وهو: ما هي نظرتنا حِيال سلوك الجنس البشري؟ وما هو تفسيرنا وتعليلنا لذلك؟ يا لروعة تَمَيُّز الإنسان وغرابته! فالحيوان تحكمه الغريزة، أمّا الإنسان فلا نظير له، فهو أعلى شأنًا من الحيوان بآلاف المرّات ويتمتّع بالمنطق والقدرة على التحليل والابداع والتعبير. وهذه قدرات عقلية مذهلة تظهر بشكل حصري في هذا المخلوق على هذه الأرض!
هذا وإنّ الإنسان يتمتّع أيضًا بوعي أخلاقي، ومعرفة خفَّية ضمن بنيته لما هو خطأ وما هو صواب، إنه نظام معقّد للمبادئ الأخلاقية. بالإضافة إلى هذا كلّه، يتمتّع الإنسان بوجود الضمير، الذي هو كالقاضي المستقل الذي في بعض الأحيان يقاوم تصرّفاتنا ضد رغباتنا. قد نفسّر ذلك بافتراضنا أن هذا النظام الأخلاقي الداخلي قد تمّت برمجته من خلال قوانين مجتمع ما في الماضي البعيد، لكن لطالما كانت هذه المعرفة للمبادئ الأخلاقية، منذ تاريخ الإنسان، مرسّخة في كيانه ولطالما أزعج الضمير الإنسان.

يمكننا أن نبرهن بأنّ للضمير معاييرًا عالمية عندما نتأمّل بعمله على الصعيد الدولي. فحتّى البلدان التي لا يوجد فيها قوانين، تستنكر حصول الأعمال السيّئة في البلدان الأخرى.
على الرغم من أن الضمير يمتلك القدرة على إزعاجنا إلاّ أنه لا يمتلك القدرة على إصلاحنا. فتبكيت الضمير يؤلمنا من حين لآخر لكننا نفشل في أن نعيش ضمن المستوى المطلوب. ففي كل مرّة نحاول أن نحسِّن حياتنا، أو نبدأ صفحة جديدة ونحرز تقدُّمًا لكي نصبح على الشكل الذي يطلبه منّا الضمير، نفشل.
كيف يمكن تفسير ذلك؟ عندنا القدرة على التمييز بين الصح والخطأ، لكننا في الواقع نفشل في اختيار ما هو صحيح؟ هناك تفسير واحد فقط لذلك، وهو التفسير الذي يعطينا إيّاه الكتاب المقدس. فقد خلقَ الله الإنسان على صورته لكن الإنسان عصى الله وابتعَدَ عنه. لقد زرع الله في داخل الإنسان مبادئ أخلاقية، لكن الإنسان الساقط لا يمكنه أن يعيش ضمن هذه المبادئ والمعايير.
لقد صُمِّم الإنسان بشكل مختلف تمامًا عن الحيوان. بالـتأكيد هنالك خصائص بيولوجية مشتركة بينهما، لكن من ناحية المنطق والضمير والقدرات العقلية المتميّزة يتبيّن بشكل ملحوظ بأن الإنسان مختلف كل الاختلاف. فالأشخاص الملتزمون اقتفاء أثر نسب الإنسان من قرد يتمسّكون ببصيص أمل حين يجدون علامة من المتحجِّرات البدائيّة تُظهر إمّا “قردًا من النوع الأسمى” وإمّا “إنسانًا من النوع الأدنى”. وهم يقومون بذلك علّهم يقدرون أن يضيّقوا الهوّة العظيمة بين الجنسين، لكنهم لم يجدوا مثل المخلوق البشري قط. ومن حين لآخر، تظهر تقارير حسّية لتدّعي هذه الاكتشافات بناءً على وجود بقايا فتات من العظام المتحلّلة، وخلال فترة وجيزة تفقد هذه الادّعاءت مصداقيّتها وتُرفض. لو كان أصل الإنسان قردًا لكان هنالك الآلاف من المتحجّرات البدائيّة إلاّ أنه لا يوجد أي أثر لهذه المتحجّرات.
لقد ذكَرنا سابقًا خصائص متميّزة للكائن البشري ومن ضمنها القدرة على التعبير. فالإنسان يمتلك قدرة عظيمة على اكتساب مفردات اللغة وقواعدها وتركيب الجمل منذ الطفولة، على عكس الحيوان الذي تتحدّد قدرته التعبيرية على أفعال بدائية كالنخر والصرير. فالمعدّات العقلية المعقّدة التي من شأنها أن تمنح قدرة التعبير للبشر هي غير متواجدة نهائيًا في أسمى أنواع القرود.
إنّ تميُّز الكائن البشري لا يمكن انكاره أو ضحده وتميّزه هذا يثبِّت حقيقة وجود مُصمِّم إلهي للإنسان ومحدِّد للقصد من خلقه.
لقد تأمّلنا لغاية الآن، ببرهانين من أجل تثبيت الإيمان، لكن في الحقيقة هنالك براهين وحجج عدّة قام باستخدامها المؤمنون عبر التاريخ من أجل مساعدة المستفسرين.
لقد أشارَ الرسول بولس إلى هذا الموضوع من خلال الكلمات التي ورَدَت في رومية 1: 19-20، “إِذْ مَعْرِفَةُ اللهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، لأَنَّ اللهَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ، لأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ الْمَنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً بِالْمَصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِلاَ عُذْرٍ”.

بكلام آخر، إن الروائع والعجائب الظاهرة في تصميم الخليقة تؤكّد بشكل واضح على حدس الإنسان الداخلي بأنّ الله موجود.
غير أنّه لا يمكن الإجابة على السؤال، “كيف يمكنني أن أتأكّد بأنّ الله موجود؟” إلاّ من خلال اختبار شخصي معه، وهذا ما يحصل عند التجديد.
إنّ التجديد يُحدث تغييرًا جذريًّا في حياتنا، وهذا التغيير يبدأ عندما يبحث الإنسان عن المسيح ويتّخذه مخلِّصًا له. فالمسيح جاء إلى عالمنا لكي يحمل عقاب خطايا كل مَن يؤمن به. إنّ التجديد يلبّي أعظم الاحتياجات ويؤمِّن لنا غفران الخطايا ويعطينا حياة جديدة وطبيعة جديدة، كما ويعطينا امتياز الاتحاد مع الله. فالتجديد يُغيِّرنا حتى نعرف الله أكثر فندافع عنه بشكل أعظم.
كيف يمكنني أن أتأكّد بأنّ الله موجود؟ فقط عندما أختبر معاملاته في حياتي. ولكي أجده عليَّ أن أسعى نحو التجديد. عليّ أن أكون مستعدًا بأن أعترف بضعفاتي وخطاياي وأتوب عنها بكل تواضع وجدّية. يجب أن أضع ثقتي الكاملة بموت المسيح الكفَّاري على الصليب وأُسلّم حياتي
بالكلية له.
إنَّ الله يكافئ كل مَن يَجدَّ في طلبه ويؤكّد لهم خلاصهم. لذا بغية تأمين مصير نفوسنا الأبدي، علينا أن نطلب الله من كل قلوبنا ونجدّ في طلب معرفته. أن نعرف الله من خلال إيماننا بيسوع المسيح، إلهنا ومخلِّصنا، هو الملء والسلام والحياة الأبدية والقصد من حياتنا.